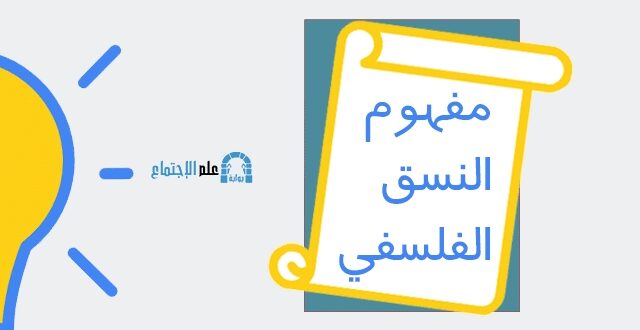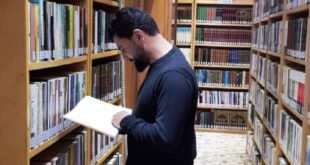النسق تعريفه وانواعه
علي ضاحي- خاص takarir.net
تنويه: هذه السلسلة من النصوص حول الفلسفة وعدة ابعاد فيها وارتباطها بين علم اهل البيت عليهم السلام ومقارنتها بالاساطير والثقافات القديمة، هي ثمرة تعاون بين موقع takarir.net ممثلاً بناشره الصحافي علي ضاحي ومؤسس ومدير ورشة السهروردي الكاتب والاديب والفيلسوف الكويتي محمد علي السعيد.
محور اول : متى ظهرت كلمة النسق في الفلسفة وعلى يد من؟
كلمة “النَّسَق” في أصلها عربية قديمة، وردت في المعاجم بمعنى التتابع، والترتيب، والتنسيق بين عناصر مختلفة ضمن كلّ واحد (يُقال: نَسَق الكلام، أي رتَّبه على نظام). لكن دخولها إلى الخطاب الفلسفي العربي ارتبط بالاحتكاك بالفكر اليوناني، خصوصًا عند ترجمة مؤلفات أرسطو وأفلاطون في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي.
???? في الفلسفة اليونانية، كان يقابلها مصطلح σύστημα (سيستِما) باليونانية، الذي تُرجم أحيانًا بـ “نظام” أو “نسق”، ويعني: الكل المكوَّن من أجزاء مترابطة.
???? أوائل من أدخل استعمالها في المعنى الفلسفي العربي هم مترجمو مدرسة بيت الحكمة ببغداد (حنين بن إسحاق، إسحاق بن حنين، ثابت بن قرة) الذين كانوا يبحثون عن مقابل عربي لـ system.
???? لكنها ترسّخت أكثر عند الفلاسفة المسلمين مثل الفارابي (ت 950م) حين تحدّث عن “نَسَق العلوم” أي ترابطها وانتظامها في كلٍّ واحد.
???? ثم جاء ابن سينا وابن رشد ليستخدموها في وصف البنية المترابطة للعلم أو للفكر.
في الفلسفة الحديثة، استُعيدت كلمة “نسق” بكثافة لترجمة كلمة system، خصوصًا مع ديكارت وكانط وهيغل، حيث صار “النسق الفلسفي” يعني بناءً متكاملًا من المبادئ المترابطة.
???? إذًا يمكن القول إن كلمة “النسق” ظهرت في الفلسفة العربية مع حركة الترجمة في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي، واستعملها بوضوح الفارابي وابن سينا، ثم تجدد حضورها في الترجمة الحديثة للفكر الأوروبي منذ القرن التاسع عشر.
النسق في الفلسفة: من الترتيب إلى البنية الشاملة
تعود كلمة النسق في أصلها العربي إلى معنى التتابع والترتيب والتنسيق بين أجزاء مختلفة تؤلّف كلًّا واحدًا. ومع ذلك، لم تدخل الكلمة إلى الخطاب الفلسفي إلا مع حركة الترجمة في العصر العباسي، حين واجه المترجمون العرب مصطلحًا يونانيًا هو σύστημα (سيستما)، ويعني: “الكل المكوَّن من أجزاء مترابطة”.
1. النسق في الفلسفة اليونانية
استخدم أفلاطون وأرسطو فكرة “النسق” دون المصطلح العربي طبعًا. عند أفلاطون نجد نسق المدينة الفاضلة، حيث كل طبقة تؤدي وظيفتها في كلٍّ متكامل. أما عند أرسطو، فالكون نفسه يُرى كنسق منظم يخضع لمبادئ أولى، والعلم بدوره يُبنى في تسلسل منطقي يبدأ من البديهيات وصولًا إلى النتائج.
2. النسق في الفلسفة الإسلامية
مع ترجمة الفلسفة اليونانية في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي، انتقل مصطلح systema إلى العربية تحت لفظ “نسق” أو “نظام”. وقد برز استخدامه خصوصًا عند الفارابي الذي تحدّث عن “نسق العلوم”، أي انتظامها في ترابط منطقي يربط الرياضيات بالمنطق فالطبيعة وما بعدها. كما استخدم ابن سينا وابن رشد هذا المفهوم لوصف انتظام الموجودات في سلم وجودي مترابط. وهكذا صار “النسق” يشير إلى بنية فكرية أو وجودية شاملة.
3. النسق في الفلسفة المدرسية واللاتينية
في أوروبا الوسيطة، استُعيدت كلمة systema باللاتينية لتشير إلى الترابط بين العلوم واللاهوت. كان توما الأكويني مثلًا يقدّم اللاهوت كنسق يضم الفلسفة الطبيعية والأخلاق والسياسة ضمن رؤية لاهوتية متكاملة.
4. النسق في الفلسفة الحديثة
مع القرن السابع عشر، صار مفهوم “النسق” أساسًا في التفكير الفلسفي. عند ديكارت نجد “النسق العقلي”، أي بناء المعرفة على أساس من المبادئ الواضحة البديهية. أما كانط فقد عرّف الفلسفة بأنها “علم نسقي”، أي علم يردّ مبادئه إلى وحدة عقلية واحدة. في حين طوّر هيغل هذا المفهوم إلى أقصاه حين اعتبر الفلسفة “نسقًا جدليًا مطلقًا”، يضم التاريخ والفكر والواقع في تطور واحد شامل.
5. النسق في الفلسفة العربية الحديثة
مع حركة النهضة والترجمة في القرن التاسع عشر، عاد مصطلح “النسق” ليترجم كلمة system الأوروبية، خصوصًا في كتابات فرح أنطون وشبلي شميل وسواهما. وقد استُخدم في وصف الفكر الماركسي والوضعي باعتباره أبنية فكرية شاملة.
6. النسق في الفلسفة المعاصرة
اليوم، ومع البنيوية وما بعد البنيوية، تغيّر معنى النسق: لم يعد يشير إلى كلٍّ مغلق أو مطلق، بل صار أقرب إلى مفهوم البنية أو المنظومة، كما في أنساق اللغة عند دي سوسير، أو أنساق السلطة والمعرفة عند فوكو. وهكذا انتقل من فكرة الترتيب الكلّي إلى تحليل الشبكات والعلاقات.
—
خلاصة
يتضح أنّ مفهوم النسق مرّ بمراحل متعدّدة:
عند اليونان: الكلّ المنظّم.
عند الفلاسفة المسلمين: انتظام العلوم والموجودات.
عند الحداثيين: بناء عقلاني شامل.
عند المعاصرين: شبكة علاقات وبنية مفتوحة.
وبذلك يظل النسق مفهومًا حيًّا، يتغير مع السياقات الفلسفية، لكنه يحتفظ بجوهره: التفكير في الكلّ عبر ترابط الأجزاء.
محور آخر: النسق هو الرحمة الني تجمع مابين الضيافة والاجارة وهما ايضا التنمية والحماية
وهذا تطوير للنسق على يد ورشة السهروردي
اقتراح لتطوير النسق: [3:07 PM, 9/7/2025] Ali Dahi: الفكرة هي ربط النسق بمستوى إنساني وروحي أوسع من البنية الفلسفية الجامدة.
أنت تعرّف النسق بأنه الرحمة الجامعة التي توحّد بين الضيافة والإجارة، وهما بدورهما يعادلان في لغة التنمية الحديثة: التنمية والحماية.
إذا أخذنا هذا التصور، فـ”تطوير النسق” يعني توسيع دائرة الرحمة بحيث تصبح أكثر شمولًا، وتدمج أبعادًا إضافية في علاقتها بالإنسان والمجتمع والطبيعة.
—
كيف نطوّر النسق في هذا المعنى؟
1. التوسعة المفهومية
أن نرى النسق ليس مجرد ترتيب معرفي، بل بنية قيمية وروحية.
الرحمة تصبح المبدأ الأعلى الذي يحكم التنمية (الإعمار، البناء، الإبداع) والحماية (العدل، الأمان، رعاية الضعفاء).
2. إدخال أبعاد جديدة
البُعد البيئي: الرحمة لا تشمل الإنسان فقط، بل الأرض والطبيعة.
البُعد الاجتماعي: النسق الرحمي يدمج التضامن والعدالة الاجتماعية.
البُعد الكوني: الضيافة لا تقتصر على الآخر القريب، بل تمتد لتشمل الإنسانية جمعاء (وحتى البُعد الديني الروحي: ضيافة الله لعباده).
3. تفعيل النسق عمليًا
في التنمية: أن يكون البناء قائمًا على إشراق، لا على استهلاك.
في الحماية: أن تكون القوانين والأنظمة قائمة على العدل الرحمي، لا على الردع وحده.
في الثقافة: أن تُبنى المعرفة على تواصل بين العلوم والإنسانيات والدين، بدل أن تبقى متفرقة.
4. الانتقال من الثنائي إلى الدائري
النسق يبدأ عندك بثنائية (ضيافة–إجارة / تنمية–حماية).
لتطويره يمكن إدخاله في دائرة رحمة أوسع:
الضيافة = استقبال
الإجارة = أمان
التنمية = نمو وازدهار
الحماية = صون ورعاية
→ كلها تلتقي في مركزها: الرحمة الجامعة.
5. صياغة النسق بلغة معاصرة
يمكن التعبير عنه كنموذج:
الرحمة = القيمة العليا (الغاية).
الضيافة = التنمية (الموارد والإبداع).
الإجارة = الحماية (الأمن والعدل).
النسق = شبكة تكاملية، حيث كل عنصر يُغذي الآخر في وحدة متوازنة.
—
???? الخلاصة:
تطوير النسق يتم عبر توسيع معناه من الترتيب الفلسفي إلى البنية القيمية–الرحمية التي تشمل التنمية والحماية معًا، وتربط الإنسان بالطبيعة والآخر والكون. وبهذا يتحول النسق من مجرد “بناء معرفي” إلى مشروع إنساني شامل.
—
النسق كرحمة جامعة بين الضيافة والإجارة
مقاربة فلسفية–إنسانية
المقدمة
يُعرّف النسق عادة في الفلسفة على أنه انتظام وترابط بين عناصر مختلفة تؤلف كلًّا موحَّدًا. غير أنّ النظر إلى النسق من زاوية القيم الروحية يفتح أفقًا أرحب: فالنسق يمكن أن يُفهم باعتباره الرحمة الجامعة التي تلمّ شتات الإنسان والعالم في علاقة تكاملية. في هذا التصور، الرحمة ليست عاطفة فقط، بل بنية قيميّة شاملة توحّد بين بعدين أساسيين:
الضيافة = الاستقبال والعطاء = التنمية والإشراق.
الإجارة = الحماية والأمان = العدالة والرعاية.
—
1. الرحمة كجوهر النسق
الرحمة هنا ليست مفهومًا دينيًا حصريًا، بل مبدأ كوني شامل. فهي طاقة توحيد بين الأضداد، وميزان بين الاحتياجات المادية والروحية، بين العطاء (الضيافة) والصون (الإجارة). إنها القيمة العليا التي تجعل النسق حيًّا وناميًا.
—
2. الضيافة: النسق في بعده التنموي
الضيافة هي استقبال الآخر والانفتاح عليه.
فلسفيًا، تمثّل البعد الإشراقي–الإنمائي للنسق: أي القدرة على البناء، الإبداع، وإطلاق الطاقات الكامنة.
في التنمية الحديثة، يمكن فهم الضيافة باعتبارها توسيع المجال العام ليستوعب الآخر، سواء كان إنسانًا، جماعة، أو حتى الطبيعة.
—
3. الإجارة: النسق في بعده الحمائي
الإجارة تعني الحماية وضمان الأمان للآخر.
فلسفيًا، هي البعد الحمائي–العدلي للنسق: أي القدرة على صون الحقوق وتثبيت الأمن.
في عالم اليوم، الإجارة تعادل بناء منظومات العدالة الاجتماعية والقانونية التي تحمي الفئات الأضعف.
—
4. التكامل بين الضيافة والإجارة
لا ضيافة بلا إجارة، ولا إجارة بلا ضيافة. التنمية بلا حماية تتحول إلى فوضى، والحماية بلا تنمية تتحول إلى جمود. النسق الرحمي يوازن بينهما ويجعل كلًّا منهما مكمّلًا للآخر.
—
5. تطوير النسق
لتطوير النسق في معناه الرحمي–القيمي، يمكن السير في ثلاث اتجاهات:
1. توسيع المفهوم: من الإنسان إلى الطبيعة، ومن المجتمع المحلي إلى الإنسانية جمعاء.
2. إدماج الأبعاد: الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، والروحية ضمن شبكة واحدة.
3. إعادة صياغة النسق المعاصر: بلغة الأنظمة المفتوحة، حيث الرحمة هي المحور الذي يربط بين التنمية والحماية في دائرة متوازنة.
—
الرسم البياني: النسق الرحمي
[ الرحمة ] │┌───────────────┴───────────────┐
│ │
[ الضيافة = التنمية ] [ الإجارة = الحماية ] │ │
│ │
[ الإشراق / البناء ] [ العدل / الرعاية ]
محور آخر: النسق في الفلسفات الاربع
معنى النسق في البوذية
النسق في الفكر البوذي يعني النظام الكوني – الأخلاقي – الوجودي الذي يربط كل الظواهر معًا. البوذية لا تنظر إلى العالم كأجزاء منفصلة، بل كـ”شبكة مترابطة” (Interdependent Web).
هذا النسق يُبنى على ثلاث ركائز:
1. الدارما (Dharma – التعليم/القانون الكوني)
الدارما هي القانون الذي يسير به الكون، والحقائق التي اكتشفها بوذا.
هي نسق الحقيقة التي تفسر: المعاناة، سببها (الرغبة)، إمكان التحرر، وطريق التحرر (الحقائق الأربع النبيلة).
2. الكرما (Karma – الفعل والنتيجة)
مبدأ السببية الأخلاقية. كل فعل (جسدي، لفظي، ذهني) يُنتج نتيجة.
هذا يجعل الوجود نسقًا أخلاقيًا دقيقًا: لا شيء يحدث اعتباطًا، بل في ترابط سببي صارم.
3. البراتيتيا ساموتبادا (Pratītya-samutpāda – النشوء الاعتمادي)
قانون الترابط الوجودي: “هذا يوجد لأن ذاك يوجد، وإذا زال ذاك يزول هذا”.
يفسر كيف لا يوجد كائن أو ظاهرة بمفردها، بل ضمن شبكة من الأسباب والنتائج.
—
النسق والغاية البوذية
الهدف النهائي في البوذية هو النيرفانا (Nirvāṇa): التحرر من دورة الولادة والموت (سامسارا).
هذا التحرر يتحقق عندما يفهم الإنسان النسق: يدرك أن كل ما هو مشروط فانٍ، وأن التعلق هو سبب المعاناة.
—
النسق البوذي مقابل الأنساق الأخرى
في المسيحية والإسلام: النسق يرتبط بإرادة إلهية واحدة مطلقة.
في البوذية: النسق هو قانون كوني – أخلاقي غير شخصاني، لا يرتبط بإله خالق بل بترابط الأشياء ونتائج الأفعال.
لكنه يشبه في جوهره “الرحمة الكونية” (Karuna)، حيث كل الكائنات متصلة، ومعاناتها متبادلة.
—
الخلاصة
النسق في البوذية هو:
ترابط كوني (النشوء الاعتمادي).
نظام أخلاقي (الكرما).
طريق للتحرر (الدارما).
وبذلك، يصبح النسق في البوذية ليس فقط فهمًا للعالم، بل ممارسة وجودية وسلوكية تهدف إلى تقليل المعاناة والوصول إلى التحرر.
مقارنة بين النسق في البوذية والنسق عند أهل البيت.
النسق البوذي والنسق العلوي: بين النشوء الاعتمادي والرحمة النورانية
1. النسق في البوذية
يقوم على ثلاث قواعد:
1. الدارما: الحقيقة الكونية وقانون التحرر.
2. الكرما: الفعل ونتيجته الأخلاقية.
3. البراتيتيا ساموتبادا: النشوء الاعتمادي، أي أن كل الظواهر مترابطة ومتداخلة.
هو نسق لا شخصاني (Impersonal): أي أنه لا يُدار من إله أو قوة عليا، بل من القوانين الكونية نفسها.
الغاية: التحرر من المعاناة (دوكها) عبر الوصول إلى النيرفانا، وهي حالة انطفاء الرغبات.
—
2. النسق عند أهل البيت (ع)
يقوم على ركائز قرآنية – نبوية – ولائية:
1. الرحمة: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين” (الأنبياء: 107).
2. الولاية: الأئمة (ع) هم النسق الحافظ للكون: «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها».
3. العدل: يتحقق في خاتمة التاريخ بظهور الإمام المهدي (عج).
هو نسق شخصاني نوراني (Personal – Divine): مرتبط بالله تعالى، يُدار من خلال الحجة الإلهية.
الغاية: إقامة العدالة الكونية، تحقيق الرحمة، وحفظ الوجود الروحي والمادي.
—
3. جدول المقارنة
البُعد النسق البوذي النسق عند أهل البيت (ع)
الطبيعة قانون كوني غير شخصاني (لا إله خالق) فيض رباني يُدار بالولاية والحجة
المبدأ النشوء الاعتمادي (ترابط الظواهر) الرحمة والولاية (ترابط الكون بالإمام)
الأخلاق الكرما: الفعل ونتيجته الشريعة والولاية: العمل الصالح والهداية
الغاية النيرفانا (تحرر فردي من المعاناة) العدل المهدوي (خلاص جماعي للإنسانية)
الإنسان كائن يسعى للتجاوز الفردي خليفة الله في الأرض، مرتبط بجماعة الأمة
الخلاص انطفاء الرغبة والمعاناة امتلاء الأرض قسطًا وعدلاً بالمهدي (عج)
—
4. الخلاصة
النسق البوذي هو نسق طبيعي – أخلاقي – غير شخصاني، يُبنى على فهم الترابط الكوني والكرما، وغايته تحرير الفرد.
النسق عند أهل البيت (ع) هو نسق نوراني – إلهي – شخصاني، يقوم على الرحمة والولاية، وغايته حفظ الكون بالعدل الإلهي وخلاص الجماعة.
بهذا يمكن القول إن البوذية ترى النسق في قوانين الطبيعة، بينما أهل البيت (ع) يرون النسق في رحمة الله عبر الحجة الإلهية.
الديانة الهندوسية غنية بالأنساق الفلسفية والروحية، وتختلف عن البوذية في كونها أكثر لاهوتية وتعددية، لكنها تلتقي معها في فكرة الترابط الكوني.
1. الأساس الكوني للنسق الهندوسي
النسق في الهندوسية قائم على وحدة شاملة تسمى:
برهمان (Brahman):
المبدأ المطلق، الحقيقة النهائية، الجوهر الكوني الذي يفيض منه كل شيء ويعود إليه.
النسق هنا يقوم على أن الكون ليس منفصلًا، بل تعبير عن هذا المطلق.
آتمن (Ātman):
الذات الفردية أو الروح، التي هي في جوهرها غير منفصلة عن برهمان.
النسق الروحي يقوم على اكتشاف هذا الاتحاد: “أنت ذلك” (Tat Tvam Asi).
—
2. النسق الأخلاقي والاجتماعي
الدارما (Dharma):
تعني الواجب، القانون الكوني، النظام الأخلاقي. كل فرد له دارما خاصة بحسب طبقته (فارنا)، مرحلته العمرية، وظروفه.
النسق هنا يجعل المجتمع والكون مرتبطين بواجبات مقدسة تحفظ التوازن.
الكرما (Karma):
مبدأ الفعل والنتيجة، مثل البوذية، لكن بارتباط أكبر بالدارما. العمل الموافق للدارما يقود إلى ترقي الروح، والمخالف يقود إلى دورة samsara (التناسخ).
—
3. النسق الكوني – الدورات الزمنية
سامسارا (Saṃsāra):
دورة الميلاد والموت والتناسخ المستمرة، نتيجة الكرما.
موكشا (Mokṣa):
التحرر من هذه الدورة عبر معرفة اتحاد الآتمن بالبرهمان.
يوغا (Yoga):
تمثل طرقًا عملية (التأمل، العبادة، العمل، الحكمة) لتحقيق الانسجام مع النسق الكوني والوصول إلى الموكشا.
4. الرمزية في النسق
الآلهة (فيشنو، شيفا، براهما، ديفي…): تمثل تجليات للبرهمان، وتُظهر كيف يتجلى النسق المطلق بأشكال متعددة تحفظ الكون (الخلق، الحفظ، الفناء).
النسق هنا ليس فوضويًا، بل دائريًا: الخلق يتكرر في دورات (يوغا) زمنية تمتد لملايين السنين.
—
5. خلاصة النسق الهندوسي
كونياً: برهمان هو الأصل، والآتمن امتداده في الفرد.
أخلاقياً: الدارما + الكرما تنظم المجتمع والوجود.
زمنياً: النسق دائري عبر دورات السامسارا، والخلاص هو الموكشا.
روحياً: الهدف هو إدراك الوحدة (الآتمن = برهمان)، أي الانسجام مع النسق الكوني.
—
???? يمكن القول: النسق الهندوسي هو نسق توحيدي-تعددي في آنٍ واحد: توحيدي لأن كل شيء يعود إلى برهمان، وتعددي لأنه يسمح بتجليات متعددة (الآلهة، الطقوس، طرق الخلاص).
مقارنة ثلاثية بين النسق الهندوسي والنسق البوذي والنسق عند أهل البيت (ع). سأعطيك تحليلًا وجدولًا شاملًا يوضح الفوارق والتقاطعات:
—
المقارنة الثلاثية: الهندوسية – البوذية – أهل البيت (ع)
1. النسق الكوني
الهندوسية: برهمان هو الحقيقة المطلقة، والآتمن (الروح الفردية) جزء منه. النسق دائري يقوم على الخلق – الحفظ – الفناء.
البوذية: الكون شبكة ترابط (النشوء الاعتمادي). لا برهمان ولا إله خالق، بل قوانين طبيعية – أخلاقية.
أهل البيت (ع): الكون قائم بفيض الله، ومحفوظ بالحجة (الإمام). نسق نوراني توحيدي يقوم على الرحمة والعدل.
—
2. النسق الأخلاقي
الهندوسية: الدارما (الواجب) والكرما (النتيجة). كل فرد له دارما خاصة، مرتبطة بمكانته الاجتماعية والكونية.
البوذية: الكرما مركزية، لكن الدارما تعني تعليم بوذا، لا الواجب الاجتماعي.
أهل البيت (ع): الشريعة والولاية. العمل الصالح والطاعة ضمن منظومة الرحمة والعدل.
—
3. الهدف والخلاص
الهندوسية: الموكشا (التحرر من دورة السامسارا) عبر إدراك اتحاد الآتمن بالبرهمان.
البوذية: النيرفانا (انطفاء الرغبة والمعاناة) عبر فهم الدارما واتباع الطريق النبيل.
أهل البيت (ع): النجاة بالولاية والعدل الإلهي، والخلاص الجماعي عبر المهدي (عج).
—
4. طبيعة النسق
الهندوسية: توحيدي-تعددي (الوحدة في الكثرة).
البوذية: لا شخصاني (Impersonal)، قائم على قوانين طبيعية – أخلاقية.
أهل البيت (ع): شخصاني نوراني (مرتبط بالله مباشرة وبالحجة الإلهية).
—
5. الجدول المقارن
البُعد الهندوسية البوذية أهل البيت (ع)
الأصل الكوني برهمان (المطلق) + آتمن (الروح) نشوء اعتمادي (ترابط الظواهر) الله والفيض النوراني عبر الإمام
القانون الأخلاقي دارما + كرما كرما + دارما (تعليم بوذا) شريعة + ولاية
الزمن دورات كونية (سامسارا) دورة الميلاد والموت التاريخ يسير نحو عدل مهدوي
الخلاص موكشا: اتحاد الروح بالمطلق نيرفانا: انطفاء الرغبة عدل مهدوي: امتلاء الأرض قسطًا وعدلاً
طبيعة النسق توحيدي-تعددي غير شخصاني (قوانين) شخصاني-نوراني (ولاية)
الفرد/الجماعة خلاص فردي (مع مراتب اجتماعية) خلاص فردي خلاص فردي + جماعي (الأمة والإنسانية)
—
6. الخلاصة
الهندوسية: نسق كوني – اجتماعي، يجمع بين الوحدة والتعدد، والخلاص فردي بالموكشا.
البوذية: نسق طبيعي – أخلاقي، يركز على فهم الترابط والكرما، والخلاص فردي بالنيرفانا.
أهل البيت (ع): نسق نوراني – إلهي، يركز على الرحمة والولاية، والخلاص جماعي بظهور المهدي (
النسق في الديانة/الفلسفة الكنفوشية (Confucianism)، وهي ليست ديانة بالمعنى التقليدي بل نسق أخلاقي–اجتماعي–سياسي.
—
1. الأساس الفلسفي للنسق الكنفوشي
النسق الكنفوشي يقوم على فكرة أن الكون والمجتمع والإنسان مترابطون من خلال الانسجام (Harmony) والفضيلة (Virtue). لا يتحدث عن إله خالق بالمعنى التوحيدي، بل عن:
السماء (Tiān – 天): مبدأ كوني–أخلاقي، يمثل النظام الأعلى والعدالة الطبيعية.
الطاو (Dao – 道): الطريق أو النسق الطبيعي والأخلاقي الذي يجب على الإنسان أن يسير فيه ليحقق الانسجام.
—
2. النسق الأخلاقي–الاجتماعي
الركائز الخمس (Wu Chang – 五常) تشكّل قلب النسق الكنفوشي:
1. Ren (仁 – الإنسانيّة/الرحمة): التعاطف والرحمة أساس كل فضيلة.
2. Yi (義 – العدالة/الاستقامة): الفعل الصحيح بحسب المبدأ الأخلاقي.
3. Li (禮 – الطقوس/الآداب): احترام العادات والتقاليد، نظام العلاقات الاجتماعية.
4. Zhi (智 – الحكمة): الفهم العميق للخير والشر.
5. Xin (信 – الصدق/الأمانة): الوفاء بالوعود والثقة المتبادلة.
هذه القيم تُشكل نسقًا أخلاقيًا عمليًا يهدف إلى تحقيق الانسجام في المجتمع.
—
3. النسق السياسي–الاجتماعي
المجتمع عند كونفوشيوس يشبه العائلة الكبيرة، والحاكم بمثابة الأب.
إذا كان الحاكم فاضلًا (Junzi – الرجل المثالي)، انعكس ذلك على الرعية بالانسجام.
النسق هنا مبني على التسلسل الهرمي الأخلاقي: كل فرد له دور ومسؤولية.
—
4. الهدف النهائي للنسق
تحقيق الانسجام الكوني والاجتماعي (He – 和).
تربية الفرد ليصبح Junzi (الإنسان الفاضل).
إقامة مجتمع عادل مستقر، يعكس النظام الأخلاقي للسماء.
—
5. خلاصة النسق الكنفوشي
كونياً: السماء والطاو هما النظام الأعلى.
أخلاقياً: الفضائل الخمس تشكّل لبّ النسق.
سياسياً: الحكم الأخلاقي–الأبوي أساس استقرار الدولة.
الغاية: الانسجام بين الفرد والمجتمع والكون.
—
???? يعني: النسق في الكنفوشية ليس روحياً/صوفيًا كالهندوسية أو البوذية، ولا نورانيًا إلهيًا كأهل البيت (ع)، بل هو نسق عملي–أخلاقي–اجتماعي يربط الكون والمجتمع بالفضيلة والانسجام.
غايا (Gaia)، فهي تمثل النسق الأولي الوثني في الفكر الإغريقي القديم، ومن بعدها طُورت لاحقًا في البيولوجيا والبيئة (نظرية غايا الحديثة).
—
1. غايا كأسطورة كونية (النسق الوثني)
الأصل: غايا في الميثولوجيا اليونانية هي “الأرض الأم”، الكيان الأول الذي نشأ من الفوضى (Chaos).
هي المبدأ الجامع الذي وُلد منه كل شيء: السماء (أورانوس)، الجبال، البحر، والآلهة.
النسق هنا أسطوري–شاعري: الأرض ليست مجرد مادة، بل كائن حيّ، أمّ، مغذية، حاضنة.
➡️ النسق في غايا يعني أن الأرض = النظام الكوني كله، وكل الموجودات تجلياتها.
—
2. غايا كنسق طبيعي–بيئي (التأويل الحديث)
في القرن العشرين، طُورت نظرية غايا (Gaia Hypothesis) على يد جيمس لوفلوك (1972).
الفكرة: الأرض بكاملها (محيط، جو، كائنات) تعمل كنظام حيّ واحد ذاتي التنظيم، يحافظ على التوازن (Homeostasis).
النسق هنا علمي–إيكولوجي: الكوكب مثل جسد حي، يوازن نفسه ليستمر صالحًا للحياة.
—
3. الخصائص النسقية لغايا
1. الكلية (Holism): الأرض وحدة متكاملة، لا أجزاء منفصلة.
2. التنظيم الذاتي: التوازن يحدث عبر عمليات طبيعية (مناخ، محيط، كائنات دقيقة).
3. الأنثوية: رمزية “الأم الكبرى” → الرعاية، الخصوبة، الولادة المستمرة.
4. الدائرية: الطبيعة دورات (الفصول، الموت/الحياة، المد والجزر).
—
4. النسق الغاوي مقارنة بالنسق الديني/الروحي
غايا الوثنية: أرض–أم، تجسد الحياة الكونية.
غايا الحديثة: نظام بيئي متكامل ذاتي التنظيم.
كلاهما يشتركان في رؤية الوحدة الحيوية بين كل العناصر.
—
5. خلاصة
النسق في غايا هو نسق كوني–بيئي يقدّم:
وحدة الأرض والكائنات.
توازن مستمر يحافظ على الحياة.
رمزية الأم الكبرى التي تُطعم وتُغذي وتحمي.
—
???? إذا أردنا أن نقارنها بالنسق عند أهل البيت (ع):
عند غايا: الأرض هي الأم الكبرى التي تعطي الحياة.
عند أهل البيت: الرحمة والولاية هما النسق الذي يربط الخلق بالخالق، وهم الأبواب التي من خلالها يتوزع “الفيض الإلهي” (مثل وظيفة غايا في توزيع الخصب والوجود، لكن بمستوى إلهي–نوراني).
مفهوم النسق عند أهل البيت (عليهم السلام) يمكن مقاربته من زاويتين:
1. النسق بمعناه الفلسفي والفكري
النسق في الفلسفة هو البنية الداخلية المتماسكة التي تجمع المبادئ والقيم في منظومة واحدة.
عند أهل البيت، نجد أن نسقهم هو نسق توحيدي – رحماني، يربط بين العقيدة (الإيمان بالله)، الشريعة (العمل بالواجبات والأحكام)، والإنسان (الكرامة والحرية والمسؤولية).
أي أن فكرهم لا يتجزأ، بل هو متكامل: يربط بين الروح والمعرفة والسلوك في وحدة واحدة، مثل خيط واحد يجمع حبات العقد.
2. النسق كمنهج حياة عند أهل البيت
الرحمة: هي المركز الذي يشدّ النسق كله، مصداقًا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
العدالة: تشكل عمود النسق؛ فالإمام علي (ع) جعل العدالة معيار الحكم والمجتمع.
الضيافة والإجارة: قيم ترتبط بالعيش المشترك، حيث الإنسان يُكرم الآخر ويحميه.
الاستدامة: تتجلى في وصاياهم بحفظ الأرض، الماء، الإنسان، والأجيال القادمة.
المعرفة: العلم عندهم ليس مجرد أداة، بل نور وهداية: العلم إمام العمل والعمل تابعه.
3. ملامح النسق عندهم
نسق شمولي: يجمع بين الدين والدنيا.
نسق قيموي: الرحمة، العدالة، الحرية، الكرامة.
نسق إنساني كوني: يتجاوز حدود الطائفة والزمان، ليخاطب العالم كله.
نسق ديناميكي: قابل للتفاعل مع الواقع والتطور، لكنه يحافظ على جوهره.
✨ باختصار:
النسق عند أهل البيت هو رحمة شاملة وعدالة مستمرة ومعرفة نورانية، تنظم علاقة الإنسان بربه، بنفسه، وبالآخرين، وتبني حضارة تقوم على الكرامة والضيافة والحماية والاستدامة.
النسق في فلسفة اليونان له طابع مميّز، لأنه ارتبط بمحاولتهم الأولى لبناء نظام فكري شامل يفسّر الكون والإنسان والحياة، بدل الاقتصار على الميثولوجيا والأساطير. ويمكن تلخيصه في عدة محاور:
—
1. معنى النسق عند اليونان
النسق عندهم هو بنية فكرية متماسكة تتكون من مبادئ أولية، وقوانين كلية، وتطبيقات عملية.
الفيلسوف اليوناني لم يكن يكتفي بجزء من المعرفة، بل سعى إلى رؤية كلية تجمع بين الطبيعة، الأخلاق، السياسة، والفن.
—
2. بدايات النسق الفلسفي
الفلاسفة الطبيعيون (طاليس، أنكسمانس، هيراقليطس): حاولوا تفسير الكون من مبدأ واحد (الماء، الهواء، النار…).
هذا التبسيط كان أول محاولة لصياغة نسق يفسّر كل شيء انطلاقًا من أصل واحد.
—
3. اكتمال النسق عند الكبار
سقراط: جعل النسق أخلاقيًا – حواريًا؛ يرى أن الفضيلة معرفة، وأن النفس محور الفلسفة.
أفلاطون: بنى نسقًا مثاليًا؛ قسم الوجود إلى عالم المثل (الحقائق الكلية الثابتة) وعالم الحس (الظلال). وضع رؤية سياسية في “الجمهورية” حيث العدالة نظام كوني – اجتماعي.
أرسطو: وضع أعظم نسق واقعي؛ ربط بين المنطق، الطبيعة، الميتافيزيقا، السياسة، والأخلاق. جعل “الغاية” (التلوس) أساس فهم الطبيعة والإنسان.
—
4. ملامح النسق اليوناني
شمولي: يربط بين الكون، الإنسان، والمعرفة.
عقلاني: يعتمد على البرهان والحجة لا على الأسطورة.
تراتبي: كل شيء له مكان وغاية في النظام الكوني.
سياسي – أخلاقي: الفلسفة ليست مجرد نظر، بل سعي لتنظيم المجتمع وفق العدالة والخير.
—
5. أثره لاحقًا
النسق اليوناني أصبح أساس الفلسفة الإسلامية والمسيحية في العصور الوسطى.
أعمال أفلاطون وأرسطو خاصةً شكلت النماذج الكبرى للنسق الفكري الذي ألهم فلاسفة مثل الفارابي، ابن سينا، وابن رشد.
—
✨ إذن: النسق في الفلسفة اليونانية هو منظومة عقلية شاملة ترى أن الكون منظم وفق مبادئ كلية، وأن على الإنسان أن يعيش منسجمًا مع هذا النظام عبر الفضيلة والعقل.
محور رابع: ما هو النسق عند هيكل وكانت؟
عندما نتحدث عن النسق عند هيكل وكانت، نحن أمام مفاهيم فلسفية مختلفة، لأن كل واحد منهما يتعامل مع النسق وفق منظوره الخاص. إليك التفاصيل:
—
1️⃣ النسق عند كانت (Immanuel Kant)
كانت (1724–1804) الفيلسوف الألماني، ويعد مؤسس الفلسفة النقدية. عنده:
النسق = نظام المعرفة البشري الذي يمكّن العقل من فهم العالم.
الهدف: إيجاد ترتيب منطقي بين ما يدركه الإنسان (الحواس) وما يضيفه العقل (الفهم).
مكونات النسق:
1. الحواس: تأتي بالمعطيات الخام (المظاهر).
2. العقل والفهم: ينظم هذه المعطيات وفق قواعد ثابتة (الفئات العقلية).
نتيجة النسق عند كانت: الإنسان يمكنه فهم الظواهر، لكن الأشياء في ذاتها (Noumena) تبقى خارج الإدراك البشري.
ملحوظة: النسق عند كانت فلسفي – معرفي، يركز على الترتيب الداخلي للمعرفة، وليس على الأخلاق أو الدين فقط، رغم أن فلسفة الأخلاق عنده تستند إلى العقل والواجب (Imperative categorical).
—
2️⃣ النسق عند هيجل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
هيجل (1770–1831) الفيلسوف الألماني، معروف بالنسق الجدلي – الكلي.
النسق = التطور الكلي للواقع والفكر وفق حركة جدلية (Dialectic):
1. الأطروحة (Thesis) → 2. النقيض (Antithesis) → 3. التركيب (Synthesis)
الهدف: كشف الوحدة الكلية للواقع، حيث كل شيء يتطور ويجد مكانه في النسق الشامل.
النسق عند هيجل:
كلي، منطقي، تاريخي: كل الظواهر مرتبطة وتتطور نحو الكمال.
يشمل العقل، الطبيعة، التاريخ، الروح (Spirit).
ملحوظة: النسق عند هيجل ليس مجرد ترتيب للمعرفة، بل هو حركة الحياة والفكر والروح نحو الكمال الكلي.
—
3️⃣ مقارنة سريعة بين كانت وهيجل في مفهوم النسق
المحور كانت هيجل
طبيعة النسق معرفي – نقدي – داخلي للعقل جدلي – كلي – تاريخي وواقعي
العلاقة بالواقع ينظم الخبرات لتكوين معرفة عن الظواهر الواقع والفكر يتطوران معًا في حركة جدلية
الهدف فهم حدود العقل والظواهر الوصول إلى الكل المطلق (Absolute) وفهم تطور الواقع والفكر
التركيز الحواس والعقل والفهم التاريخ، الروح، الفكر، الطبيعة
طريقة الترتيب ثوابت داخلية للعقل (فئات) حركة جدلية مستمرة: أطروحة → نقيض → تركيب
—
باختصار:
كانت: النسق وسيلة العقل لتنظيم المعطيات وفهم العالم الظاهري.
هيجل: النسق حركة كونية كلية، يجمع الفكر والواقع والتاريخ ضمن تطور جدلي نحو الكل المطلق.
مخطط مفاهيمي يربط بين النسق عند:
1. أهل البيت (عليهم السلام)
2. كانت
3. هيجل
سأوضح الأساس، الهدف، المكونات، وطبيعة النسق لكل منهم.
—
مخطط المقارنة بين النسق الثلاثة
┌───────────────────────────────┐
│ النسق عند أهل البيت │
└───────────────────────────────┘
│
┌────────────────────┼─────────────────────┐
│ │ │
الرحمة العدالة المعرفة
(الإنسان محور النسق) (قيم اجتماعية) (نور وهداية)
│ │ │
└───────────────> شمولية تجمع بين الروح، الإنسان، والمجتمع <───────────────┘
│
ديناميكي ومرن، يشمل الحياة العملية والروحية
┌───────────────────────────────┐
│ النسق عند كانت │
└───────────────────────────────┘
│
┌────────────────────┼─────────────────────┐
│ │ │
الحواس العقل الفهم
(المظاهر) (تنظيم المعطيات) (القوانين والفئات)
│ │ │
└───────────────> النسق معرفي، نقدي، يحدد حدود فهم الإنسان للظواهر <───────────────┘
│
لا يصل للأشياء في ذاتها (Noumena)
┌───────────────────────────────┐
│ النسق عند هيجل │
└───────────────────────────────┘
│
┌────────────────────┼─────────────────────┐
│ │ │
الأطروحة النقيض التركيب
(Thesis) (Antithesis) (Synthesis)
│ │ │
└───────────────> النسق جدلي، كلي، تاريخي، تطوري <───────────────┘
│
يشمل العقل، الطبيعة، التاريخ، والروح في حركة نحو الكمال المطلق
---
تحليل سريع للتقاطع والاختلاف
أهل البيت vs كانت:
كلاهما يهتم بالترتيب والانسجام، لكن أهل البيت يربطون بين العقل والروح والفضائل، بينما كانت يركز على تنظيم المعرفة العقلية فقط.
أهل البيت vs هيجل:
كلاهما شمولي وديناميكي، لكن أهل البيت يقوم على القيم الأخلاقية والرحمة، وهيجل على الجدلية والمنطق الكلي والتاريخ.
كانت vs هيجل:
النسق عند كانت معرفي داخلي، عند هيجل كلي وجدلي خارجياً وداخلياً.
محور خامس: النسق في النظريتين البنيوية والتفكيكية
البنيوية (Structuralism) والتفكيكية (Deconstruction)، لتصبح المقارنة شاملة بين خمسة مفاهيم للنسق: أهل البيت، كانت، هيجل، البنيوية، التفكيكية.
---
النسق عند البنيوية والتفكيكية
1️⃣ النسق عند البنيوية (Structuralism)
الأساس: اللغة والرموز والهياكل التي تشكّل الواقع والمعنى.
الهدف: كشف البنية الخفية للنصوص، المجتمع، والفكر.
المبدأ: كل عنصر في النسق مرتبط بالعناصر الأخرى، لا معنى له بمعزل عنها.
مثال: كل كلمة في اللغة تأخذ معناها من علاقتها بالكلمات الأخرى، وليس بمعناها الفردي.
الطبيعة: نسق ثابت نسبيًا، لكنه يعكس أنماط العلاقات الداخلية، وليس قيمة أو غاية أخلاقية.
2️⃣ النسق عند التفكيكية (Deconstruction)
الأساس: النصوص والمعاني ليست ثابتة، بل متحركة ومتناقضة.
الهدف: الكشف عن التوترات والاختلافات الداخلية للنسق، وتفكيكه لإظهار عدم استقراره.
المبدأ: لا وجود لمعنى مطلق؛ كل نظام يمكن تفكيكه وتحليله لفضح تناقضاته.
الطبيعة: نسق ديناميكي، غير مطلق، يؤكد على عدم الاستقرار والتعددية في المعنى.
البنيوية (Structuralism) والتفكيكية (Deconstruction)، لتصبح المقارنة شاملة بين خمسة مفاهيم للنسق: أهل البيت، كانت، هيجل، البنيوية، التفكيكية.
---
النسق عند البنيوية والتفكيكية
1️⃣ النسق عند البنيوية (Structuralism)
الأساس: اللغة والرموز والهياكل التي تشكّل الواقع والمعنى.
الهدف: كشف البنية الخفية للنصوص، المجتمع، والفكر.
المبدأ: كل عنصر في النسق مرتبط بالعناصر الأخرى، لا معنى له بمعزل عنها.
مثال: كل كلمة في اللغة تأخذ معناها من علاقتها بالكلمات الأخرى، وليس بمعناها الفردي.
الطبيعة: نسق ثابت نسبيًا، لكنه يعكس أنماط العلاقات الداخلية، وليس قيمة أو غاية أخلاقية.
2️⃣ النسق عند التفكيكية (Deconstruction)
الأساس: النصوص والمعاني ليست ثابتة، بل متحركة ومتناقضة.
الهدف: الكشف عن التوترات والاختلافات الداخلية للنسق، وتفكيكه لإظهار عدم استقراره.
المبدأ: لا وجود لمعنى مطلق؛ كل نظام يمكن تفكيكه وتحليله لفضح تناقضاته.
الطبيعة: نسق ديناميكي، غير مطلق، يؤكد على عدم الاستقرار والتعددية في المعنى.
---
مخطط مقارنة شامل بين النسق الخمسة
المحور أهل البيت كانت هيجل البنيوية التفكيكية
الأساس الرحمة، العقل، المعرفة الحواس والفهم الجدلية والمنطق الكلي اللغة والرموز والهياكل النصوص والمعاني المتناقضة
الهدف بناء الإنسان والمجتمع تنظيم المعرفة وفهم الظواهر الكشف عن الكل المطلق كشف البنية الداخلية تفكيك النسق وفضح التناقض
الطبيعة كلي، ديناميكي، أخلاقي معرفي – نقدي كلي، تاريخي، جدلي نسق ثابت نسبيًا نسق متحرك، غير مستقر
التركيز الإنسان، المجتمع، الروح العقل وحدود المعرفة العقل، الطبيعة، التاريخ، الروح العلاقات بين العناصر التوترات والاختلافات الداخلية
الشمولية شمولي روحياً واجتماعياً محدود للمعرفة الظاهرية شمولي فكري وتاريخي محدود للغة والأنماط محدود لتحليل النسق والنصوص
العلاقة بالواقع عملي وأخلاقي معرفي – فلسفي واقعي – تاريخي – فكري تحليلي رمزي تحليلي نقدي
---
✨ تحليل سريع:
أهل البيت: نسق روحي وأخلاقي وإنساني.
كانت: نسق معرفي داخلي.
هيجل: نسق جدلي كلي تاريخي.
البنيوية: نسق هيكلي تحليلي للغة والمعاني.
التفكيكية: نسق مرن ديناميكي يكشف التوترات والتناقضات.
مقارنة الإنساق بين هيكل، كانت، أهل البيت، البنيوية، والتفكيكية
مقدمة
الإنساق تمثل طرق تنظيم المعرفة والفهم حول الإنسان والعالم. من خلال خمسة أطر فكرية وفلسفية، يظهر اختلاف رؤية كل نسق لماهية العلاقات الداخلية، القيم، والمعايير التي تحكم الكائنات والظواهر. هذه الدراسة تقارن الإنساق الخمسة من حيث التنظيم، الثبات، المرجعية، والغاية.
---
1. نسق هيكل
الطبيعة: نسق تاريخي-ثقافي اجتماعي.
التركيب: يعتمد على علاقات التاريخ، المجتمع، والثقافة.
المرجعية: التجربة الإنسانية عبر الزمن، والبيئة المحيطة.
الثبات: نسق ديناميكي يتغير مع التحولات التاريخية.
الغاية: فهم الإنسان من خلال نسق العلاقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية.
---
2. نسق كانت
الطبيعة: نسق أخلاقي عقلاني.
التركيب: يربط الفرد بالقوانين الأخلاقية العامة (الواجب).
المرجعية: العقل العملي والمبادئ الأخلاقية المطلقة.
الثبات: نسق ثابت نسبياً، لأن المبادئ الأخلاقية لا تتغير.
الغاية: توجيه السلوك البشري نحو الكرامة، الحرية الأخلاقية، والاستقلالية العقلية.
---
3. نسق أهل البيت
الطبيعة: نسق روحي-أخلاقي شامل.
التركيب: يدمج البعد الروحي مع الأخلاقي والاجتماعي.
المرجعية: الوحي الإلهي والأئمة المعصومين.
الثبات: نسق ثابت من حيث المبادئ، لكنه قابل للتطبيق العملي وفق السياق البشري.
الغاية: تحقيق الكمال الروحي والأخلاقي للإنسان، وتنمية المجتمع عبر الرحمة والعدل.
---
4. النسق البنيوي
الطبيعة: نسق لغوي-اجتماعي.
التركيب: العلاقات بين العناصر داخل نظام معين (لغة، ثقافة، مؤسسات).
المرجعية: البنى التي تحدد العلاقات بين العناصر.
الثبات: نسق نسبي وثابت داخلياً، لكنه قابل للتغير عند تعديل البنية الكلية.
الغاية: تحليل وفهم الظواهر البشرية والاجتماعية من خلال نسق العلاقات، وليس الأفراد وحدهم.
---
5. النسق التفكيكي
الطبيعة: نسق نصي-تحليلي مفتوح.
التركيب: يقوم على تحليل التوترات والانقسامات داخل النصوص والمفاهيم.
المرجعية: اللغة والسياق والتفسير المستمر.
الثبات: نسق غير ثابت، دائم الانفتاح على تعدد المعاني والتفسيرات.
الغاية: الكشف عن تعددية المعاني، تفكيك الثوابت، وإظهار التحولات المخفية في النسق.
---
مقارنة تحليلية للإسناد والخصائص
البُعد هيكل كانت أهل البيت البنيوية التفكيكية
طبيعة النسق تاريخي-ثقافي اجتماعي أخلاقي عقلاني روحي-أخلاقي لغوي-اجتماعي نصي-تحليلي
التركيب الداخلي ديناميكي حسب العلاقات التاريخية ثابت حول المبادئ الأخلاقية ثابت في المبادئ، مرن بالتطبيق علاقات داخل البنية متغير، يعتمد على السياق
المرجعية التجربة الإنسانية العقل والمبادئ الأخلاقية الوحي والإرشاد الإلهي البنى الاجتماعية واللغوية النص واللغة والسياق
الثبات متغير ثابت نسبياً ثابت في المبادئ نسبي داخلياً غير ثابت
الغاية فهم الإنسان والمجتمع توجيه السلوك الأخلاقي تحقيق الكمال الروحي والأخلاقي فهم العلاقات والنسق الكشف عن تعدد المعاني والتفسيرات
---
خاتمة
تُظهر المقارنة أن الإنساق الخمسة تختلف في المصدر المرجعي، مستوى الثبات، وطبيعة التركيب. من النسق التاريخي عند هيكل، إلى النسق الأخلاقي عند كانت، مروراً بالنسق الروحي عند أهل البيت، ثم النسق البنيوي الذي يركز على العلاقات، وأخيراً النسق التفكيكي الذي يكشف عن تعدد المعاني. كل نسق يقدّم رؤية مميزة لفهم الواقع، الإنسان، والمعرفة، ويكشف عن تعدد الأساليب العلمية والفلسفية في مقاربة المفاهيم.
[author title="الصحافي علي ضاحي" image="https://takarir.net/wp-content/uploads/2021/07/ali-dahi-1.png"]ناشر ورئيس تحرير موقع تقارير[/author]
 موقع تقارير موقع تقارير
موقع تقارير موقع تقارير